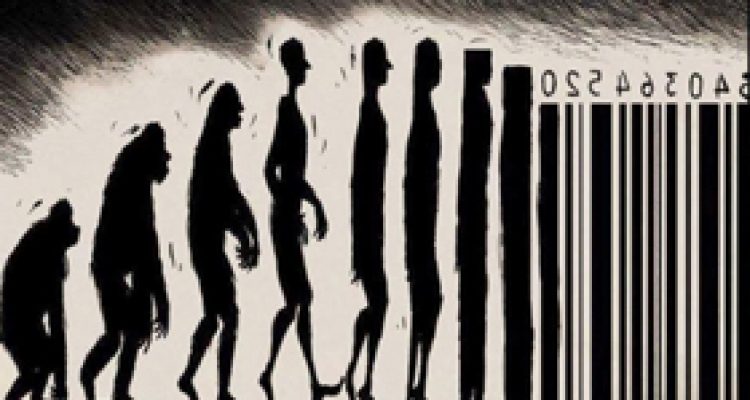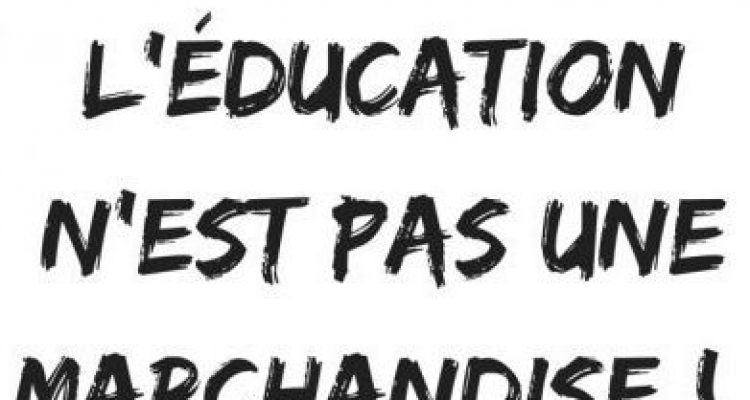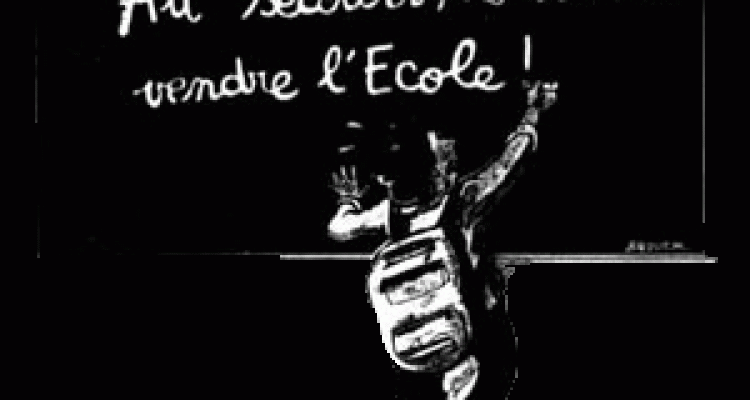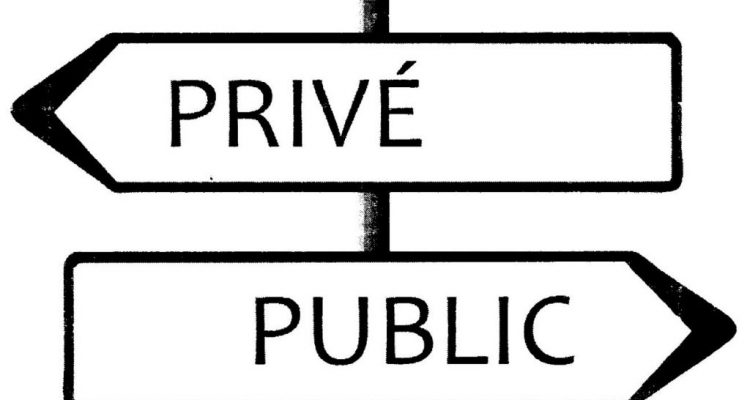انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل صور وفيديوهات لملعب حديث، بمناسبة احتضان المغرب بطولة كأس افريقيا 2025 في كرة القدم، بعد تساقطات مطرية، تُظهر أرضيته وقد امتصّت المياه بكفاءة لافتة، دون برك أو تعطّل، في مشهد “نظيف” ومُتقَن. المشاهد، التي حظيت بإعجاب واسع، تحوّلت في المقابل إلى شاهد إدانة إذا قورنت بما يجري على بعد كيلومترات قليلة: أحياء شعبية غارقة، طرق مقطوعة، منازل تسرب إليها الماء، وشبكات صرف صحي عاجزة عن استيعاب أمطار عادية.
المفارقة فاقعة: الدولة قادرة تقنيًا وماليًا على إنجاز بنى تحتية عالية الجودة حين يتعلق الأمر بالملاعب والمنشآت المرتبطة بالواجهة الدولية، لكنها تعجز أو تتقاعس عن تعميم الحد الأدنى من المعايير نفسها على الأحياء التي يسكنها العمال والفقراء. الملعب لا يغرق، لأن له نظام تصريف مُصمم ومُمَوَّل ومُراقَب. بينما الحي الشعبي يغرق، لأن الاستثمار فيه غير مربح سياسيًا أو اقتصاديا.
هذه الصورة ليست مسألة “تفوق تقني” للملعب فحسب، بل خلاصة لاختيارات طبقية. فحيث توجد كاميرات العالم، تُصرف الأموال بسخاء وتُحترم دفاتر التحملات. وحيث يعيش الناس بعيدًا عن الأضواء، تُترك الشوارع لقوانين الارتجال، وتُسند الأشغال بأقل تكلفة، وتغيب الصيانة. النتيجة: ملعب يمتص المطر، ومدينة تختنق به.
من طنجة إلى آسفي: أمطار تفضح هشاشة متجذرة
مع كل موجة أمطار، يتكرر المشهد نفسه في مدن مغربية عديدة: شوارع تتحول إلى برك مائية، أحياء تُعزل عن محيطها، طرق رئيسية تُغلق، ومرافق عمومية تفشل في أداء أبسط وظائفها. ما حدث مؤخرًا في طنجة، برشيد، آسفي، تطوان، وجماعات محيطة بمراكش، لا يمكن اختزاله في “تقلبات مناخية استثنائية”، بل يكشف هشاشة بنيوية مزمنة في شبكات الصرف و الطرق والتجهيزات الأساسية، وهي هشاشة تنجلي كل سنة دون معالجة جذرية.
في طنجة، مدينة المشاريع الكبرى والواجهة المتوسطية، لم تكن أمطار بالغزيرة، لإغراق شوارع بكاملها، وشل حركة السير، وتعطيل الحياة اليومية. هذا العجز لا يرتبط بحجم التساقطات، بل بفشل شبكات التطهير السائل في التعامل حتى مع كميات متواضعة من المياه، ما يعكس اختلالًا هيكليًا في التخطيط الحضري وفي صيانة البنية التحتية. المشهد ذاته تكرر في برشيد، المدينة التي تربط الدار البيضاء بالرباط، حيث غرقت أحياء كاملة، وتوقفت الحركة التجارية، وتعطلت مصالح السكان بسبب قنوات صرف غير مؤهلة وانعدام تدخل مؤسسات الدولة المختصة.
في آسفي، لم تعد المسألة مجرد اضطراب يومي، بل تحولت الأمطار إلى مأساة إنسانية حقيقية: تتفاوت الإحصائيات المتداولة بشأن عدد القتلى ( أرقام تقول 37 قتيلا وأخرى 40 ) وعشرات المصابين، ومؤسسات تعليمية متضررة. هذه الكارثة لم تكن مفاجئة، بل نتيجة مباشرة لبنية تحتية عاجزة عن حماية السكان من مخاطر يمكن التنبؤ بها والاستعداد لها. وفي جماعة الويدان قرب مراكش، كما في مناطق أخرى، أدت الفيضانات إلى عرقلة التنقل حتى في الطرق الأساسية، مهددة سلامة التلاميذ والمرضى، ودافعة السكان إلى المطالبة بإصلاحات بسيطة: تقوية شبكات تصريف المياه وتأهيل الطرق.
تكشف هذه الوقائع المتكررة تناقضًا صارخًا في أولويات الإنفاق العمومي. بينما ترفض الدولة ضمان صرف صحي فعال وطرق صالحة للاستعمال في أحياء واسعة، لا تتوانى عن ضخ أموال طائلة في مشاريع كبرى ذات طابع رمزي واستعراضي، وعلى رأسها الملاعب والبنيات المرتبطة بالفعاليات الرياضية الدولية.
الميزانية تتكلم : الملاعب أولًا… والحقوق الاجتماعية إلى حين
وفقا للأرقام، ميزانية 2026، خصصت الدولة 1.1 مليار درهم لتطوير المنشآت الرياضية ومواصلة بناء وتأهيل الملاعب في إطار التحضير لكأس العالم 2030، إضافة إلى 500 مليون درهم لملاعب القرب داخل المؤسسات التعليمية. وقبل ذلك، في ميزانية 2024 وحدها، خُصص حوالي 1.97 مليار درهم لبناء وتأهيل الملاعب الكبرى، مثل الملعب الكبير للدار البيضاء وتوسيع طاقته الاستيعابية. هذه الأرقام، تعبّر بوضوح عن أولوية سياسية موجهة نحو الاستثمار في بنى رياضية مرتبطة بالسمعة الدولية.
في المقابل، ورغم رفع ميزانية الصحة والتعليم في 2026 إلى حوالي 140 مليار درهم، فإن هذا الارتفاع جاء بعد ضغط اجتماعي واسع، ولا تزال نتائجه محدودة على أرض الواقع. فالمستشفيات العمومية تعاني من خصاص كبير في الأطباء والمعدات، خصوصًا في المناطق البعيدة، وهو ما فجّر احتجاجات متكررة. ينضاف إلى حجم الميزانية، طبيعة توزيعها ونجاعة صرفها، مقابل سخاء واضح حين يتعلق الأمر بالمشاريع الرمزية.
يصبح التفاوت أكثر فجاجة عند مقارنة بعض الأرقام: أكثر من 20 مليار درهم خُصصت لتجهيز الملاعب استعدادًا للبطولات الدولية، في حين لم تتجاوز المساعدات الرسمية لإعادة بناء منازل متضررة من زلزال مدمر 4.6 مليار درهم. هذا الفرق لا يعكس فقط خللًا ماليًا، بل يعكس تصورًا لما يُعتبر أولوية استثمارية.
أشارت تقارير أن المغرب خصص حوالي 52.5% من ميزانيته العامة سنة 2024 لمشاريع البنية التحتية الكبرى: النقل والملاعب و الموانئ والتجهيزات المرتبطة بالفعاليات الدولية، ما جعله في صدارة الدول العربية في هذا المجال. رغم ذلك، لا ينعكس هذا الإنفاق الضخم على جودة الطرق المحلية، ولا على شبكات الصرف الصحي، ولا على الخدمات الصحية والتعليمية اليومية، وهو ما يطرح سؤال الجدوى الاجتماعية لهذا “النموذج التنموي” الاستثماري.
فمثلا في اقليم بن سليمان وهذا غيض من فيض، جرى تفكيك مدارس وبنايات أساسية لصالح بناء ملعب، من دون توفير بدائل مناسبة، ما جعل بعض التلاميذ يسافرون عشرات الكيلومترات للوصول إلى مدارس بعيدة بلا وسائل نقل لائقة.
ختاما : التنمية لفائدة من ؟
ما يُسوَّق كإنجاز “تنموي” عبر مشاريع كبرى موجهة للعرض الدولي لا يوازيه أي التزام فعلي بتحصين حياة الفئات الشعبية من المخاطر المتكررة. فبينما تُصرف مليارات الدراهم على ملاعب وقطارات وموانئ تخدم صورة واندماج الدولة العالميين، يُترك جزء واسع من المجتمع داخل بنية تحتية هشة تعجز عن توفير الحد الأدنى من الأمان. هنا لا يظهر عجز الدولة عن الجودة، بل انتقائيتها: معايير صارمة للواجهة، وعدم اهتمام ممنهج حين يكون المتضرر هو المواطن البسيط.
ما نعيشه ليس خللاً أو فشلًا تقنيًا يمكن إصلاحه ببعض الترقيعات، بل نتيجة مباشرة لخيارات تنموية نيوليبرالية جعلت من الاستثمار أداة لخدمة الرأسمال والصورة الدولية، لا وسيلة لضمان الحقوق الأساسية. حين تُحصَّن الملاعب وفق أعلى المعايير، بينما تُترك الأحياء الشعبية والقرى عرضة للفيضانات والمخاطر، فإن ذلك يكشف بوضوح أن الدولة تدير بمنطق الانتقائية الطبقية: حماية ما يدرّ الربح والسمعة، والتكيف مع الهشاشة حين يكون المتضررون هم الفقراء والكادحون.
إن هذا النموذج التنموي، القائم على تمويل المشاريع الكبرى الموجهة للتصدير والفرجة الدولية، مقابل إهمال البنيات الاجتماعية الأساسية، يعمّق الفوارق ويعيد إنتاج التهميش بدل معالجته. فلا طرق آمنة، ولا صرف صحي فعّال، ولا خدمات صحية وتعليمية قادرة على الصمود أمام أبسط الأزمات، في مقابل خطاب رسمي يحتفي بالأرقام والإنجازات. من هنا، فإن معركة البنية التحتية ليست مسألة تقنية، بل معركة سياسية واجتماعية حول من يستفيد من الثروة العمومية، ولصالح من تُوجَّه الميزانيات، وأي مجتمع نريد: مجتمع يحمي الإنسان، أم دولة تُجيد التزيين وتترك الشعب يواجه المطر والوحل وحده.
بقلم وحيد عسري