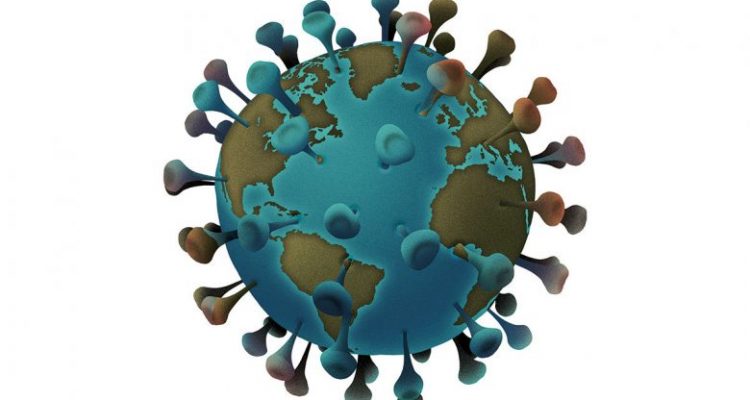يُعرِّف نعوم تشومسكي “الدولة الفاشلة” بـ”عدم القدرة أو عدم الرغبة في حماية مواطنيها من العنف وربما من الدمار نفسه… والعجز عن تأمين الأمن لسكانها”. [1].
لقد كشفت الدولة المغربية عن كونها “دولة فاشلة”، والأكيد أن “عدم حماية مواطنيها من الدمار وعدم تأمين الأمن لسكانها”، ليس مردُّه “عدم قدرتها” بل “عدم رغبتها” في ذلك. ثبتَ هذا في كل أحداث عنف الطبيعة وما يواكبها من دمار، في زلزال الحوز سنة 2023 وفيضانات طاطا سنة 2024، وفيضانات آسفي سنة 2025، وأخيرا وليس آخرا فيضانات الشمال سنة 2026. ما يؤكِّد “عدم الرغبة” وليس”عدم القدرة”، هو أن الدولة قادرة على حشد الأموال والقدرات البشرية لإنجاح محطات دولية (وآخرها كأس أمم فريقيا)، وأيضا القدرة على تعبئة الإمكانات المالية الجبارة لتجهيز بنية تحتية ضخمة (من سدود وطرق سيارة ومدن صناعية… إلخ)، موجَّهة لخدمة القطاع الخاص (الأجنبي والمحلي)، في حين “تفشل” في توفير الحدود الدنيا من تلك البنية التحتية الموجَّهة لـ”حماية مواطنيها من العنف وربما من الدمار نفسه، وتأمين الأمن لسكانها”.
دعاية إعلامية لمنجزات اقتصادية تخفي أوجه الهشاشة الفعلية
ترعى الدولة دعاية إعلامية جبارة موجَّهة للرأي العام الخارجي، تصوِّر نفسها “دولة صاعدة في أفريقيا”، وبلدَ المنجزات الاقتصادية الضخمة. هذا التناقض بين صورة دولة صاعدة وبين واقع الحال الاجتماعي هو ما فجَّر نضالات القرويين في صيف 2025 وبعدها نضالات جيل- زد، التي حملت شعار “لا نريد كأس العالم، الصحة أولا”.
تنكشف حقيقة تلك المنجزَات الاقتصادية كلما واجَه السكان كارثة طبيعية. وتظهر تلك الدولة الصاعدة على حقيقتها: عدم رغبةٍ صريحة في تقديم يد المساعدة للسكان. هذه الدولة الصاعدة والمحقِّقة إنجازات اقتصادية، اعتمدت أكثر الوسائل بدائية في مواجهة فيضانات الشمال: إفراغ حقينة السدود وإخلاء كلي لسكان المناطق المهدَّدة وتهجيرهم إلى مدن أخرى، دون توفير مسبَق لمستلزمَات ذلك الإخلاء والتهجير: مواقع الاستقبال والإسكان، توفير الحاجيات الأساسية من سكن وغذاء لمن جرى إخلاؤهم- هن وتهجيرهم- هن وانقطعت بذلك سُبل عيشهم… إلخ.
حل أزمة الماء: انكشاف خرافة الدعاية
من بين ما ركّزت عليه دعاية الدولة: “اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية”. تعتمد الدولة نفس استراتيجية المؤسسات المالية الدولية: في وجه أزمات الاقتصاد والمناخ التي سببتها الرأسمالية، لا سبيل لامتلاك استراتيجية طويلة الأمد، والحل الوحيد هو التكيُّف الظرفي مع كل أزمة ظرفية.
لقد ركَّزت الدولة طيلة السنوات السابقة، على تدبير أزمة الإجهاد المائي والندرة، فإذا بالتغيُّر المناخي (المسؤولة عنه الرأسماليةُ طبعا) يأتي بالنقيض: فيض وفير من المياه يهدد حياة السكان وأمنهم. أظهرت السدود حقيقة سبق أن نبه إليها الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي: “إننا على طرف نقيض من شروط الفعالية ودون الحد الأدنى من النجاعة”. [2].
سياسة ماءٍ موجَّهة لخدمة القطاع الخاص وليس لخدمة السكان
تبنَّت الدولة منذ ستينيات القرن العشرين سياسة تشجيع القطاع الفلاحي التجاري الموجَّه للتصدير، ورعت ولادة برجوازية فلاحية تجارية، مخصِّصة لذلك موارد مالية هائلة ومُعفية تلك البرجوازية من الضرائب. كتب نجيب أقصبي عن ذلك: “… كانت ‘سياسة السدود’ سياسة تدخل كثيف وانتقائي للدولة، حيث إنها لم تكتف بتشييد السدود الكبرى الهيدروليكية وقنوات الري التي مدت أراضي المُزارع الخاص بالماء مجانا تقريبا، وإنما عبأت أيضا ترسانة من المساعدات العمومية المختلفة لتشجيع المُزراع على الاندماج كليا في دينامية التراكم والتحديث: الماء بفاتورة مخفَّضة أو بالمجان وإعفاءات ضريبية شبه مستمرة ودعم سخي من أجل اقتناء مختلف التجهيزات والمعدات وقروض بنسب فائدة معَّمة وضمان أسعار مجزية و/ أو تنظيم قنوات للتسويق واتفاقيات تجارية تسمح بفتح أسواق خارجية وتكوين وبحث خاص بالقطاع… ونظرا لهذه الشروط، نفهم كيف تكونت بسرعة ثروات خاصة هائلة في ظل هذه الهِبة العمومية”. [3].
وفي مواجهة أزمة ندرة المياه تبنَّت الدولة خطة تحلية المياه، ووجَّهت أولويتها مرة أخرى لخدمة نفس الرأسمال الفلاحي/ التجاري الموجَّه نحو التصدير. وما دامت السدود ومحطات تحلية المياه تخدم جيدا تلك الأولوية، فإن توقُّع المخاطرِ التي تهدد أمن وحياة السكان، لا تدخل في نطاق اهتمامات وانشغالات الدولة، ما يُضفي عليها كل خصائص الدولة الفاشلة، كما عرَّفها تشومسكي.
بعد عقود من سياسات سدود مموَّلة من المالية العمومية بشكل كثيف، لم تنفع تلك السدود في مواجهة قطبي أزمة الماء: فلا نُدرة ماءِ عولِجت ولا فيضَ ماءِ دُرِءَ.
التوقع والأرصاد: غلبة المنطق التجاري على منطق حماية السكان
في جواب وزير الطاقة والمعادن على أسئلة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2014، ورد ما يلي: “إن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إدارة عمومية مهمتها الرئيسية تتمثل في حماية أرواح وممتلكات المواطنين عبر تقديم خدمات في مجال التنبؤات والإنذار وعلم المناخ”. لكن هذا الجواب مجرَّدُ إعلان خطابي، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات ذاته.
بيَّن هذا التقرير، وبالأرقام، أن المنطق الذي يحكم مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هو المنطق التجاري، أكثر من “حماية أرواح وممتلكات المواطنين”، كما بيَّت أيضا فيضانات الشمال حاليا، صحة ذلك.
تشتغل مديرية الأرصاد الجوية بمنطق تقديم الخدمات التجارية، وبالتالي فإن خدماتها ستوجَّه إلى ما تسميه المديرية “الشركاء الاقتصاديين” [4]، أي للقطاع الذي يستطيع أن يؤمِّن لها مردودا ماليا. هذا ما أقرَّه تقرير المجلس الأعلى للحسابات (2014): “حققت مديرية الأرصاد الجوية، في سنة 2013، رقم معاملات قدره 94.7 مليون درهم: تُقدم المساعدة للملاحة الجوية الذي يمثل معظمَ النشاط التجاري لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية. حيث إن رقم المعاملات الذي تم تحقيقه مع المكتب الوطني للمطارات يمثل %80 من إجمالي رقم المعاملات المحقق في عام 2013. وتمثل الوكالة الوطنية للموانئ الزبون الثاني لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية من حيث رقم المعاملات بما يقرب من %6 من عائدات عام 2013”. [5].
وهكذا فإن %86 من مداخيل المديرية تتأتى من قطاعين اثنين، هما المكتب الوطني للمطارات والوكالة الوطنية للموانئ. إن سكان مدينة القصر الكبير التي تُعد، حسب تصريح يونس الحبوسي لموقع الناس [6]: “تُعَد من المدن التي تعاني من الهشاشة والفقر بشكل كبير”، هؤلاء السكان ليسوا “سوقا مضمونة” لمديرية أرصاد تعتمد المنطق التجاري. حسب هذا المنطق السكان ليسوا “زبائن جيدين” عكس “الشركاء الاقتصاديين”.
ليست مجرَّد اختلالات تدبير وأداء بل سياسة تقشف نيوليبرالي
تقرير المجلس الأعلى والحسابات لسنة 2014، هو التقرير الوحيد الذي تحصلنا عليه لتكوين صورة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، لكنه يتضمن معلومات غنية عن تلك المديرية، هذه بعضها:
* “إن برنامج التحديث لمحطات المديرية سجل تأخرا كبيرا وغير مبرَّر. وللتذكير فإن البرنامج الذي انطلق في عام 2010، ليستمر إنجازه لمدة ثلاث سنوات، لم يكتمل بعد حتى حدود نهاية عام 2014″؛
* “إن تراكم الخبرة في إدارة البيانات وتطوير النماذج ليس في المستوى المطلوب”؛
* “إن شبكات الرصد المناخية غير كافية، من حيث العدد والتوزيع مما لا يسمح بإنجاز دراسات مناخية موثوق منها”؛
يشير التقرير، بشكل خجول إلى السبب الذي يفسِّر هذه الاختلالات، بجملة يتيمة: “ضعف الإصدارات على مستوى نفقات الاستثمار”. لكن في مواجهة هذه الضعف في الاستثمار يواجهنا المجهود الاستثماري الجبار الذي تخصصه الدولة لتجهيز البنية التحتية الموجَّهة لاستقطاب الاستثمار الخاص، وأيضا لبناء ملاعب ضخمة لاستقبال محطات رياضية (كان 2025 وكأس العالم 2030). لا يتعلَّق الأمر إذن بـ”ضعف الاستثمار”، بل بتخصيص واعٍ وممنهَج للثروة الوطنية بما يضمن خدمتها للرأسماليين المحليين والأجانب.
خصص قانون مالية سنة 2026، على سبيل المثال لا الحصر، 84 مليون درهم لتوطيد شبكة الرصد الجوي. ماذا تشكِّل هذه الميزانية الهزيلة جدا (أقل من عُشُر المليار الواحد)، مقارنة مع مليارات الدراهم الموجَّهة لبناء الملاعب؟
إلا أن المجلس الأعلى للحسابات لا يدعو إلى التخلي عن “المنطق التجاري” (أي الرأسمالي) الذي يحكم على مديرية الرصاد الجوية بأن تظل مجرَّد مقدِّم خدمات مؤداة عنها لمن يستطيع ضمان أرباح أكثر، بل يدعو أكثر من ذلك إلى توسيع ذلك المنطق: “ينبغي أن تُسهم مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في تطوير سوق الخدمات المرتبطة بمجالات الطقس والمناخ”.
طبعا ليست مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، إلا مثالا بسيطا عن كيف تشتغل كل مؤسسات الدولة، مثال فرضته فيضانات الشمال. ولنا أن نتصوَّر كيف ستتفاقم الاختلالات المذكور أعلاه، والمسجَّلة سنة 2013، مقارنة مع السنوات الحالية حيث الظواهر المناخية وصلت حدودا متطرِّفة جدا، بينما هزالة الميزانية المخصَّصة للأرصاد الجوية لا تزال على حالها.
منظومة إعلام ضعيفة أم منطق رأسمالي؟
ركزت تغطيات صحافية عديدة على غياب المعطيات الرسمية الدقيقة بخصوص فاجعة الشمال. لكن هذا لا يقتصر على ما بعدَ الفاجعة، بل على ما قبلها وهو ما يفاقِم الكارثة. فحسب موقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يقع ضمن اختصاصاتها ما يلي:
* “يقوم خبراء الأرصاد الجوية بدراسة الخرائط الجوية و بتحليل ومقارنة معطيات جميع النماذج العددية المتوفرة لدى المديرية إضافة إلى فهم تأثير الكتل الهوائية على المغرب والمناطق المجاورة…”؛
* “إصدار التوقعات على شكل معلومات مبسطة وسهلة الفهم لعموم المواطنين والشركاء الاقتصاديين”.
وحسب تقرير الملجس الأعلى للحسابات: “يُعتبر ضمان الأنشطة المتصلة بالمعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ، اللازمة لتلبية جميع احتياجات المستخدَمين على المستوى الوطني، واحدة من المهام الأساسية التي تتولاها مديرية الأرصاد الجوية. ويرتبط بسلامة الأشخاص والممتلكات. ولذلك يحظى بالأولوية القصوى مقارنة بالأنشطة الأخرى”. إلا أن واقع الفيضانات الحالية والسابقة، يُظهِرُ أن هذه المُهمة هي آخر ما تقوم به مديرية الأرصاد الجوية، وهو ما أوردناه أعلاه في مقتبسات تقرير المجلس الأعلى للحسابات (2014). وطبيعي جدا ألا تقوم مديرية أرصاد جوية تعاني من تلك الاختلالات بمهامها تجاه المواطنين- ات، ما دامت تلك المديرية تحت سياسة دولة تحكم عليها بـ” ضعف الإصدارات على مستوى نفقات الاستثمار”، مديرية تشتغل بمنطق توفير الخدمات لمن يضمن لها أرباحا وليس “حماية السكان”.
كارثةُ ما بعَد الكارثة
تعاملت الدولة مع فيضانات الشمال بأكثر الوسائل بدائية: الإخلاء والتهجير، دون إعداد مُسبَق لشروط ذلك. اضطر السكان الذي أُجبروا على إخلاء سكنهم، إلى تأمين حاجياتهم بناءً على قدراتهم المالية الذاتية! وأي قُدرة مالية تتبقى لمن خرَّبت الفيضانات ممتلكاتهم- هن؟ في مدن الجلاء اضطر السكان إلى اكتراء شقق. وهذا طبعا يتأمَّن فقط للقادر على الأداء، أما العاجزون- ات فإنهم- هن يفترشون الشوارع. ولتفادي وضع الدولة ومنطق المجتمع الرأسمالي موضع الاتهام، توجَّهت الأصابع مرة أخرى إلى “تجار الأزمات”، وعجَّت وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار عن تجار يبيعون الشمعة بـ 15 درهما! كما توجّهت في السابق إلى “الشنَّاقة” لتفسير أزمة قطيع الماشية، وإلى شركات الطاقة الاحتكارية لتفسير غلاء الوقود… إلخ.
لقد قضت الدولة منذ عقود على القطاع العمومي في السكن والنقل وتأمين الغذاء. لذلك فإن الكوارث الطبيعية تفاقِمها هذه السياسة النيوليبرالية. فدولة تجعل من التجارة والأداء والقدرة على الأداء شروطا لازمة للحصول على الحقوق في “الأوضاع الطبيعية”، لا يمكن أن تسترجع المنظور العمومي والمجاني في لحظات الأزمات… إلا تحت ضغط النضال طبعا.
طيلة سنوات جعلت الدولة من رأسماليي قطاع العقار أطفالَها المدلَّلين وعبأت في صالحهم العقار العمومي والملك الخاص للدولة، ودعمتهم بمختلف التحفيزات المالية والجبائية. ولا يزال حلم الكادح المغربي أن يتمكن قبيل وفاته من استكمال أداء فاتورة دَين السكن. وفي لحظة الكوارث يظهر وجه الدولة الفاشلة، إذ إن السكن الخاص لا يُمكن فتحه في وجه ضحايا الكوارث، إلا بتبني سياسة إسكان عمومية، وهذه تتناقض مع سياسة الدولة الموجَّهة لخدمة القطاع العقاري الخاص. لذلك جرىت الإشارة أعلاه إلى إن الدولة المغربية فاشلة ليس لـ”عدم قدرتها” على حماية السكان بل لـ”عدم رغبتها في ذلك”.
من إجل إعادة الاعتبار لمنطق الخدمة العمومية
يُعَد المغرب من بين البلدان الأكثر تعرُّضا لأزمة المناخ ومظاهره المتطرفة. ورغم ادعاء الدولة تبني سياسات خضراء، ضمنها مخططات التكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من مخاطرها، إلا أن اندراج تلك السياسات في إطار المنطق الرأسمالي ذاته، يجعل منها مجرد واجهة لاستقطاب رضا المؤسسات المالية الدولية وفي نفس الوقت ضمان اللجوء إلى التمويل المناخي.
ليس المشكل في “عدم قدرة الدولة”، بل في “عدم رغبتها”. أيْ سياسةٌ واعية ممنهَجة موجَّهة لخدمة القطاع الرأسمالي الخاص، وما يترتَّب عنه من جعل كل مناحي الحياة البشرية سلعة، ومن التمتع بالحقوق (صحة وتعليم وسكن وتشغيل) ومن ضمان النجاة في وجه الموت مرَضا وبسبب الكوارث رهينة بالقدرة على الأداء.
لا يمكن الخروج من هذا المأزق سوى بإعادة الاعتبار لمنطق الخدمة العمومية، التي قضت عليها الدولة بسياسة نيوليبرالية منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين. يجب توجيه الثروة الوطنية نحو القطاعات التي تضمن تعليما وصحة وسكنا وتشغيلا للشعب، وتوجيهها نحو بنية تحتية تساهم في التخفيف من كوارث المناخ، وليس لبناء الملاعب والمناطق الصناعية التي تُوجَّه لخدمة الشركات المتعددة الجنسيات والرأسماليين المحليين.
بقلم: علي أموزاي- عضو جمعية أطاك، مجموعة إنزكان
إحالات
[1]- نعوم تشومسكي (2021)، “لأننا نقول ذلك”، ترجمة أحمد الزبيدي، دار المدى للثقافة والفنون، الطبعة الأولى، ص 12 و143.
[2]- نجيب أقصبي (أبريل 2024)، “الاقتصاد المغربي تحت سقف من زجاج، من البدايات إلى أزمة كوليد- 19″، ترجمة نور الدين سعودي، المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية- عدد 36، سلا- المغرب، ص 129.
[3]- نفسه، ص 80- 81.
[4]- موقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، https://www.marocmeteo.ma/ar/التوقعات-الجوية.
[5]- المجلس الأعلى للحسابات (2016)، “التقرير اسنوة”، https://www.courdescomptes.ma/ar/publication/التقرير-السنوي-للمجلس-الأعلى-للحسابا-4/.
[6]- Enass Media (04-02-2026)، “القصر الكبير: نزوح وخوف وصمت”، https://enass.ma/ar/القصر-الكبير-نزوح-وخوف-وصمت/.