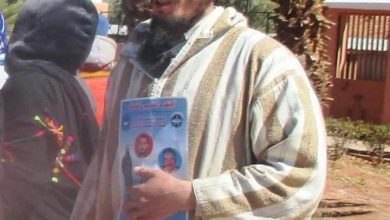جون بودريار
عنف العولمة
ترجمة سمير بوسلهام
هل العولمة قدر مشؤوم؟ إن كل الثقافات الأخرى غير ثقافتنا فرت – بشكل أو بآخر- من قدر التبادل المتهور . فأين هي العتبة النقدية للمرور إلى الكوني، ثم إلى العالمي؟ ما هذا الدوار الذي يدفع الناس إلى تجريد الفكرة [الكونية]، و هذا الدوار الآخر الذي يدفع إلى التحقق اللامشروط للفكرة؟
لأن الكوني كان فكرة، لكن ما إن تتحقق هذه الفكرة في العالمي حتى تنتحر كنهاية مثالية. لقد أصبح الإنساني هو اللحظة المرجعية الوحيدة، و أخذت الإنسانية المحايثة لذاتها، المكان الفارغ لله الميت، سيسود الإنساني إذن وحده من الآن فصاعدا، لكنه لازال يفتقر لغاية نهائية. ليس له عدو، لكنه ينتجه داخله، و يفرز كل أنواع التحولات المرضية اللاإنسانية.
هنا يكمن عنف هذا العالم – عنف نظام يلاحق كل أشكال السلب و التميز، وهو يتضمن هذا الشكل الأقصى من التمايز، الذي هو الموت ذاته – عنف مجتمع يمنعنا افتراضيا من النزاع، و من الموت – عنف ينهي بشكل من الأشكال العنف ذاته، و يعمل على إنجاز عالم متحرر من كل نظام طبيعي، سواء تعلق بالجسد و الجنس [ذكر/ أنثى]، والولادة أو الموت. زيادة على العنف، ينبغي الحديث عن الخبث. إنه عنف فيروسي: يشتغل بواسطة عدوى و عن طريق تفاعل متسلسل، إنه يهدم تدريجيا كل مناعاتنا وقدرتنا على المقاومة.
ومع ذلك، فالألعاب لم تنتهي ، و العولمة لم تكسب الرهان بعد. ففي وجه هذه القوة التي تُذيب و تُجانس، نرى في كل مكان أن القوى المتعددة – و التي ليست مختلفة فحسب، بل متعارضة – تهب في وجهها. فوراء هذه المقاومات السياسية و الاجتماعية التي تنشط أكثر فأكثر ضد العولمة، يجب أن نرى أن الأمر يتجاوز مجرد رفض لما هو عتيق: إنه نوع من نزعة التعديل المُمَزقَة، أمام مكتسبات الحداثة و” التقدم”، و ليس رفضا للبنية التقنية العالمية، بل للبنية المعنوية للتساوي مع كل الثقافات. هذا النبذ يمكن أن يتخذ أوجها عنيفة وشاذة ولا عقلانية في نظر فكرنا المتنور – أشكال جماعية إثنية و دينية و لغوية -، لكنها أشكال فردية عصابية و تمييزية. سيكون من الخطأ أن ندين هذه الجهود بوصفها شعبوية وقديمة أو إرهابية، إن الذي يصنع الحدث اليوم هو الواقعة [ 11 سبتمبر ] في مقابل هذه الكونية المجردة – إنها تحوي عداء الإسلام للقيم الغربية، (فهو طرف في النزاع الأكثر احتداما لهذا فهو يعتبر العدو رقم واحد).
من يستطيع دفع النظام العالمي للانهيار؟ ليس الحركة المناهضة للعولمة بالتأكيد، لأن كل ما ترمي إليه هو الحد من الاختلال. لكن يمكن لتأثيرها السياسي أن يكون ملحوظا، لكن تأثيرها الرمزي يكون منعدما. إن هذا العنف هو كذلك نوع من التغير الداخلي غير المتوقع، و الذي يمكن للنظام أن يتجاوزه و أن يظل هو سيد اللعبة.
ما يمكنه أن يؤدي بالنظام إلى حافة الانهيار، ليس هو البدائل الإيجابية، و إنما التمايزات. لا نعتبر هذه الأخيرة لا إيجابية و لا سلبية. إنها ليست بدائل، إنها من نظام آخر. إنها لا تخضع مطلقا إلى حكم قيمة، ولا إلى مبدأ من مبادئ الواقع السياسي. يمكنها إذا أن تكون الأحسن أو الأسوأ. يمكننا إذن أن ندرج هذه التمايزات داخل حركة تاريخية للكل. إنها تقضي على كل فكر أحادي و مهيمن. لكنها ليست فكرا مضادا أحاديا – إنها تبدع لعبتها وكذا قواعد لعبها الخاصة.
ليست التمايزات عنيفة بالضرورة، بل إنها تحوي أشياء لطيفة ، مثل اللغات و الفن و الجسد أو الثقافة. لكنها تحوي كذلك ما هو عنيف- و الإرهاب جزء منه. إن التمايزات هي من يثأر لكل الثقافات المتمايزة التي كان اختفاؤها ثمنا لتقوم هذه القوة العالمية الوحيدة.
لا يتعلق الأمر إذا “بصدام للحضارات”، لكن بمواجهة شبه أنتروبولوجية، بين ثقافة كونية غير متمايزة، و بين كل من يحتفظ بشيء من الغيرية – في أحد المجالات أيا كانت – لا يمكن اختزالها أو تجاهلها.
بالنسبة للقوة العالمية، التي لا تقل تعصبا عن الأرتودوكسية الدينية، فإن كل الأشكال المختلفة و المتمايزة تعتبر مجرد هرطقات. و على هذا الأساس فهي مدعوة للانضمام إلى النظام العالمي إما طوعا أو كرها، أو للاختفاء.
إن مهمة الغرب (أو لنقل الغرب السابق، بما أنه لم تعد له مند زمن طويل قيم خاصة به ) هي إخضاع مختلف الثقافات للقانون المفترس للتساوي، باستعمال كل الوسائل. ثقافة فقدت قيمها لا يمكنها إلا أن تنتقم من قيم الآخرين. حتى الحروب – بما فيها حرب أفغانستان- تهدف أولا، و فيما وراء الاستراتيجيات السياسية أو الاقتصادية، إلى تقويم الهمجية، و إلى ضرب كل الأقاليم بانتظام. الهدف هو اختزال كل منطقة عاصية، واحتلال و تدجين كل المجالات المتوحشة، سواء على مستوى المجال الجغرافي أو المعنوي.
إن تحقق النظام العالمي، هو نتيجة غيرة شرسة: غيرة ثقافة غير متمايزة و من طراز وضيع اتجاه ثقافات من طراز عال- غيرة أنظمة فقدت سحرها ، وحيويتها، إزاء الثقافات ذات الكثافة [الرمزية] العالية-، غيرة مجتمعات فقدت قداستها أمام الثقافات أو الأشكال القربانية.
بالنسبة لنظام كهذا، كل شكل عصيان، إرهابي بشكل افتراضي[1]، نفس الأمر ينطبق على أفغانستان. ففي إقليم حيث كل الرخص والحريات “الديمقراطية” – بما فيها الموسيقى، التلفاز أو حتى وجه النساء- يمكن تحريمها، حيث يمكن لدولة أن تتخذ موقفا للمواجهة الشاملة لكل ما نسميه حضارة – مهما كان المبدأ الديني الذي يتم الاستناد إليه- هذا ما لا يمكن تحمله بالنسبة لباقي العالم ” الحر”. فلا مجال لأن تتمكن الحداثة من التنكر في إطار ادعائها الكوني. حتى لا تظهر كدليل للخير والمثال الطبيعي للنوع [الإنساني]. فيتم وضع كونية أخلاقنا و قيمنا موضع الشك، هذا ما يتم وصفه فورا بالتعصب من طرف بعض العقول، وهذا ما يعتبر كذلك إجراميا في نظر الفكر الأحادي وكذا في نظر الأفق التوافقي للغرب.
لا يمكن فهم هذه المواجهة إلا في ضوء الإلزام الرمزي. ولكي نفهم كراهية باقي العالم اتجاه الغرب، علينا أن نقلب كل المنظوريات. إنها ليست كراهية أولائك الذين آخذنا منهم كل شيء و لم نرد لهم شيئا، إنها كراهية أولائك الذين أعطيناهم كل شيء دون أن يتمكنوا من رده. إنها إذا ليست كراهية التفقير و الاستغلال، إنها كراهية الإهانة. وعلى أساس هذه الإهانة جاء رد إرهاب 11 سبتمبر : إهانة ضد إهانة.
إن أسوأ شيء بالنسبة للقوة العالمية ليس هو أن يعتدى عليها أو أن تدمر، بل هو أن تهان. لقد تلقت الإهانة من 11 سبتمبر، لأن الإرهابيين أصابوا هنا شيئا لا يمكن الرد عليه. وكل عمليات الثأر لم تكن سوى أداة للإيذاء المادي، لكنها كانت فاشلة رمزيا. إن الحرب ترد على الاعتداء ولكنها لا ترد على التحدي. إن التحدي لا يمكن ان يرفع سوى بإهانة الآخر بالمقابل ( ولكن بالتأكيد ليس عن طريق سحقه تحت القنابل و ليس بسجنه مثل كلب في غوانتانامو).
حسب القاعدة الأساسية دائما، يعتبر غياب المقابل هو أساس كل هيمنة. إن الهبة إذا ما كانت من طرف واحد، فإنها تعتبر فعلا سلطويا. إن إمبراطورية “الخير” و عنف “الخير”، هو تماما أن تمنح دون أن تحصل على مقابل ممكن. هو أن تأخذ مكان الله. أو مكان السيد الذي يترك الحياة تهرب من العبد، في تبادله مع عمله ( لكن العمل ليس مقابلا رمزيا، إن الجواب الوحيد إذا هو التمرد و الموت). كذلك لقد ترك الله مكانا للتضحية. في النظام التقليدي تظل إمكانية الرد [ للهبة ] متاحة، لله و للطبيعة أو لبعض المؤسسات كيفما كانت، على شكل قربان. وهذا ما يضمن التوازن الرمزي للموجودات و الأشياء. لم يعد بإمكاننا اليوم، استرداد ديننا الرمزي، لأننا لم نعد نجد رمزا نرد إليه [ الهبة] – وهنا تكمن تعاسة ثقافتنا – . ليس لأن الهبة صارت هنا مستحيلة، بل لأن الهبة المضادة أصبحت غير ممكنة، فبما أن كل السبل القربانية تم جعلها محايدة و طمسها ( لم تعد التضحية مهزلة فهي تتجلى في كل الأشكال الراهنة للنكبات .
نوجد إذا في وضعية قاسية للأخذ، الأخذ دائما، ليس من الله أو من الطبيعة، لكن من خلال جهاز تقني من التبادل المعمم و من خلال العطاء الشامل ، لقد أعطي لنا كل شيء افتراضيا، و لنا الحق على كل شيء سواء كان الأمر طوعا أو كرها. نحن في وضعية العبيد الذين تركوا على قيد الحياة، و المرتبطين بدين لا يرد. كل هذا يمكنه أن يستمر لزمن طويل بفعل الانخراط في التبادل و في النظام الاقتصادي، لكن في لحظة معينة تجرفه القاعدة الأساسية لهذا الانتقال الإيجابي، و الذي يجيب حتما على انتقال مضاد سلبي، على انحراف عنيف عن هذه الحياة المغرية، على هذا الوجود المصان، على هذه التخمة من الوجود. هذه الإعادة إلى الواهب تأخذ إما شكل عنف مفتوح ( و الإرهاب جزء منه) أو شكل رفض عاجز كذاك الذي يميز حداثتنا، كراهية الذات أو الندم، الميولات السلبية التي تعتبر الشكل المتردي للهبة المضادة المستحيلة.
ما نمقته فينا هو الشيء المظلم في حقدنا ، إنه هذا الإفراط في الواقع، هذه المبالغة في القوة و في الرفاهية، هذا الاستعداد الكوني، هذا الاكتمال الحاسم، – القدر الذي وفره المحقق الأكبر في العمق للجماهير المدجنة لدى دويستوفسكي . – بينما هذا هو ما ينبده بالضبط الإرهابيون في ثقافتنا – إنه مصدر الصدى الذي يلقاه الإرهاب ( و مصدر الإغراء الذي يمارسه.
إضافة إلى يأس المهانين و المعنفين، يستند الإرهاب أيضا على اليأس الخفي لمحظوظي العولمة، على خضوعنا الخالص لتكنولوجيا شاملة، ولواقع افتراضي ساحق، على نفوذ الشبكات و البرامج التي ربما ترسم هذا الوجه المنحط للنوع الإنساني بأكمله، على نوع إنساني أصبح “عالميا” ( ألا يأتي سمو النوع الإنساني على باقي الكوكب على صورة سمو الغرب على باقي العالم ؟ ). و يضل هذا اليأس الخفي – يأسنا- يظل دون نداء، بما انه يسعى وراء تحقيق كل الرغبات.
إذا كان الإرهاب كذلك يتعامل بهذا الإفراط من الواقعية و من خلال تبادله المستحيل، بهذه الوفرة وبدون مقابل و بهذا الحل القسري للنزاعات، فإن وهم الاستئصال هنا بمثابة شر إيجابي و شامل، كيفما كان من حيث عبثيته و من حيث افتقاده للمعنى ، فإنه صك الإدانة والحكم الذي يصدره هذا المجتمع على نفسه بنفسه.
[1] – يمكننا كذلك أن نزعم أن الكوارث الطبيعية هي شكل من أشكال الإرهاب. إن الحوادث التقنية الكبيرة، مثل حادثة تشيرنوبيل تعتبر فعلا إرهابيا و كارثة طبيعية في نفس الوقت. إن التسمم بواسطة الغاز السام ” بوبال” في الهند – حادثة تقنية- يمكنها ان تكون فعلا إرهابيا- . إن كل حادثة جوية، يمكن لأي جماعة إرهابية أن تتبناها. إن الخاصية التي تميز الأحداث اللاعقلانية هو أنها يمكن أن تنسب لأي كان و لأي شيء. وإلى أبعد حد، فبالنسبة للخيال يمكن لكل شيء أن يكون من البداية إجراميا، حتى موجة برد أو زلزال – من ناحية أخرى هذا ليس بالأمر الجديد: إبان زلزال طوكيو عام 1923، رأينا أنه تم قتل آلاف الكوريين، بوصفهم مسؤولين عن هذا الزلزال. في نظام شمولي مثل نظامنا، كل شيء له نفس التأثير في خلق اللااستقرار. الكل يتنافس للإطاحة بنظام يدعي أنه معصوم. و حسب ما تكبدناه سابقا في إطار الهيمنة العقلانية المُبرمجة، يمكننا أن نتساءل أليست الكارثة الأسوأ هي عصمة النظام [ العالمي] نفسه.