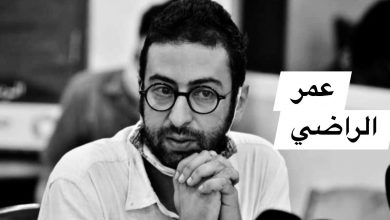عادة ما تكون الدولة والحكومة كسلطة سياسية تحت سهام النقد عن مسؤوليتها تجاه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. في أوقات الجزر تكون الآلية السياسية المعتادة هو انتقاد الحكومات والإعداد لجولة انتخابات قادمة، أما في حالات الهبَّات النضالية، يتصدر شعار إسقاط أو إقالة الحكومات الموقف. هذا ما شهدناه مثلا في النضالات الأخيرة التي خاضها الشباب تحت لواء حَراك جيل- زد بالمغرب. فما مدى مسؤولية الحكومات عن الأوضاع التي تهب تلك النضالات ضدها؟
سياق مغربي خصوصي
في السياق المغربي حيث الاستبداد السياسي، فإن المؤسسات (الحكومة والبرلمان) والأحزاب ليس لديها أي هامش سلطة أو صلاحية اتخاذ القرار. هذا الأخير بنص الدستور يوجد في مؤسسات خارج الحكومة وخارج البرلمان، وهي مؤسسات غير منتَخبة، مثل المجلس الوزاري الذي يرأسه المَلك، وله صلاحيات واسعة جدا: التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، مشاريع القوانين التنظيمية، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية… إلخ (الفصل 48 من الدستور). لذلك لا يترك المجلس الوزاري لمجلس الحكومة سوى صلاحية تنفيذ ما يقرره المجلس الوزاري.
ورغم ذلك فإن الانتقادات تتجه دوما نحو الواجهة الحكومية، بدل أن تتجه صوب المجلس الوزاري الذي يملك فعلا صلاحية التقرير، نازعا إياها من يد البرلمان المفترَض أن يكون السلطة التشريعية الوحيدة.
إخفاء مسؤولية الشركات
إلا أن هذا السياق السياسي الخصوصي بالمغرب، لا يعني أن الدول الديمقراطية تكون فيه الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن الخيارات الكبرى التي تؤثر في المجتمع وحياة الناس. بل هناك سُلطة جرى إخفاؤها بعناية من طرف وسائل الإعلام ودعاية أيديولوجية مكثَّفة، وهي سلطة الشركات والرأسماليين.
يتحدث تشومسكي في كتاب “ضبط الرعاع” عن هذه الخدعة والإخفاء قائلا: “هناك شعور في البلاد أن الناس عرضة للهجوم. واعتقد أنهم مخطئون في تحديد مصدر الهجوم، لكنهم يشعرون أنهم عرضة للهجوم. عقود من الحملات الدعائية المكثفة من قطاع الأعمال صُمِّمت لجعلهم يرون الحكومة عدوا لهم، الحكومة التي هي بنية السلطة الوحيدة في النظام المسؤول إلى حد ما أمام المواطنين- لذا فمن الطبيعي أنك تريد أن تجعلها العدو- لا نظام الشركات المتحدة، الذي هو كلية غير مسؤول. بعد عقود من الحملات الدعائية، يشعر الناس أن الحكومة نوع من العدو وأنه يجب عليهم الدفاع عن أنفسهم أمامها” [1].
في السياق المغربي عند التركيز عن سلطة الشركات، عادة ما يجري نعت ذلك بشعار: “زواج السلطة والثروة”، أو في سياق الانتخابات يجري الحديث عن “سلطة المال”. والنتيجة حسب هذه الانتقادات هي شعار: “فصل السلطة عن الثروة”، وكأن كل شيء سيجري على ما يُرام عندما يُفصَل بينهما. لذلك في سياق الاحتجاجات الأخيرة، وحتى قبلها، أي طيلة الولاية الحكومية الأخيرة التي يترأسها عزيز أخنوش، هناك حديث متواتر عن “تضارب المصالح”، إشارة إلى استغلال عزيز أخنوش لموقعه الحكومي من أجل السيطرة على فرص اقتصادية يحرم منها رأسماليين آخرين.
الاستنتاج السياسي هو أن الاقتصاد سيسير على ما يرام والمشاكل الاجتماعية ستنتفي، أو على الأقل، ستقل ما أن يجري “الطلاق بين الثروة والسلطة”. لكن ما يجري التغافل عنه هو أن المال سلطة. فالرأسمال ليس مجرد نقود يجري استثمارها، إنه علاقة اجتماعية بين طرفين غير متساويين: الرأسماليون الذين يمتلكون ويحتكرون وسائل الإنتاج من جهة، والطبقة العاملة المحرومة من أي وسيلة لاكتساب الرزق سوى بيع قوة عملها. لذلك فإن امتلاك الرأسمال يعطي لأفراد معدودين في المجتمع، أي (الرأسماليون)، سلطة جبارة عمن لا يمتلك سوى قوة عمله (العضلية أو الذهنية).
يستعمل الرأسماليون قوتهم الاقتصادية كي يستأثروا على السلطة السياسية، وهذا مشهود في كل بقاع العالم، وتمويل الشركات الكبرى للحملات الانتخابية في الولايات المتحدة وشراء ولاء أعضاء الكونغرس وسيلة للتأثير في قرارات الحكومات لصالح تلك الشركات وأربابها. والموجودون على رأس السلطة السياسية يعملون بدورهم على استغلال مواقعهم السياسية تلك من أجل إنماء ثروتهم وقوتهم الاقتصادية. فالعديد من وزراء الولايات المتحدة ينتهون أعضاءً في مجالس إدارات شركات قدموا لها خدمات سياسية عندما كانوا في الحكومة.
السلطة الخفية
عندما تحدَّث آدم سميث عن “اليد الخفية” للسوق كان يقصد بها القوانين الموضوعية للسوق التي يمكنها أن تعالج تشويهاتها دون حاجة إلى تدخل الحكومة. لكن ما غفل عنه أن المجتمع عندما تسيِّره قوانين السوق الموضوعية، فإنها تجعل القرار الحقيقي في يد المستفيدين من قوانين السوق تلك… وبالتالي ترتد مقولته بأن “السعي وراء المصلحة الخاصة يخدم المصلحة العامة” إلى مجرد غطاء يستر المصالح الخاصة ويحميها من أي رقابة اجتماعية.
وهذا ما يجعل أعرق الديمقراطيات البرجوازية في البلدان الغربية، لا تخدم مصالح المواطنين- ات والمنتخِبين- ات، بل مصالح الشركات والرأسماليين. ولأن الحكومة هي من يوجد في موقع المسؤولية الظاهرة، فإنها تُخفي المسؤولية الشخصية لتلك الشركات والرأسماليين، وهو ما أسماه نعوم تشومسكي “إزاحة القوة الحقيقية عن الساحة” التي ساهمت فيها وسائل الإعلام التي “تُضلِّل بشكل ضخم من خلال التركيز على أن الحكومة هي العدو”، بينما العدو هو “المؤسسات الديكتاتورية- وهي في الوقت الحاضر عالمية من حيث الحجم- والتي تسيطر على الاقتصاد وعلى الكثير من الحياة الاجتماعية”. [2].
في كتاب قيِّم لجوسي أبلبي بعنوان “الرأسمالية، ثورة لا تهدأ”، توصيف حي لهذا الواقع: “ففي ظل وحود أفراد وشركات خاصة تتصرف بناء على ما تعتقد أنه أفضل ما يحقق المصلحة، يكون من الصعب معرفة ما يجري بوجه عام. وما من أحد- كما لم يكن أحد من قبل- مسؤولا عما يحدث” [3]،- وتُلقَى مسؤولية الكوارث الاقتصادية وما تسببه من مآسي وآلام اجتماعية على الحكومات، التي يَفرِض عليها الرأسماليون، في لحظات الأزمات، التدخل لإنقاذ الشركات، لا لإنقاذ المجتمع والناس. شهدنا هذا مع خطط الإنقاذ المالي، التي اتخذت أحجاما هرقلية، إبان الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008، رغم أن من سعت تلك الخطط لإنقاذه هو نفسه الذي تسبب فيها: البنوك والشركات العقار والشركات الاستثمارية.
وعندما يهب الناس للاعتراض على هذا الواقع ويرفضون أن تكون حياتهم رهن “سلطة خفية غير شخصية”، ويطالبون بتغيير أسس المجتمع، آنذاك تتدخل “العقب الحديدية” للدولة من أجل إنقاذ “اليد الخفية للسوق”… وهو ما شهدناه في موجة القمع والاعتقالات والمحاكمات الماراطونية ضد شباب جيل- زد مؤخرا في المغرب.
السلطة الخفية في السياق المغربي
للمغرب، شأنه شأن البلدان “النامية”، سياقه الخصوصي عن البلدان المتقدمة. فضعف البرجوازية لحظة الحصول على الاستقلال السياسي، دفع الدولة للتدخل عبر سياسة اقتصادية نشيطة، كي تَحُلَّ مؤقتا محل تلك البرجوازية الضعيفة. وعبر قطاع عام متوسع واستثمار عمومي ضخم، أنشأت بنية تحتية وقطاعات إنتاجية عمومية، استولت عليها البرجوازية في ما بعد عبر سياسة الخوصصة. ولأن المهيمن على السلطة السياسية هو الرأسمال الكبير الملتف حول المَلكية، فقد تصدَّر الهيمنةَ على الاقتصاد، وهو ما تستاء منه أقسام أخرى من الرأسماليين، منادين بتطبيق قانون التنافس الشريف والرأسمالية النقية… إلخ.
قسم مهم من القرارات والخيارات التي تؤثر في المجتمع وحياة الناس يُتخَّذ خارج المؤسسات المنتخَبة، يُتخَذ من جانب أشخاص معدودين، هم أصحاب الشركات والرأسماليين. حسب دستور 2011 “تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر”، وهكذا فإن قرارات الاستثمار تُتَّخذ من طرف الشركات والرأسماليين المتنافسين. مثلا يُقرِّر الرأسماليون الزراعيون ما سيستثمرون فيه بناء على ما يُحقِّق لهم الأرباح، وهو التصدير إلى الأسواق الخارجية (خاصة أوروبا)، وليس بناء على ما يحتاجه المغاربة على موائد طعامهم. وهذا يُفقد البلد سيادته الغذائية ويهدد أمنه الغذائي ويسبب في موجات التضخم وغلاء مواد الاستهلاك. وليس في المغرب حاليا لأي مؤسسة منتخَبة (حكومة كانت أو برلمان) أي سلطة لمحاسبة الرأسماليين الزراعيين على خياراتهم وعلى استنزافهم للبيئة (ماء وتربة).
أما الاستثمارات الأجنبية فقد أصبحت عمليا خارج نطاق أي رقابة، ولها حرية الدخول والخروج من المغرب، ويضمن لها “ميثاق الاستثمار” نقل أرباحها إلى الخارج بكل حرية. قرارات الاستثمارات الأجنبية تُتخذ في بلدها الأصل وليست خاضعة لأي رقابة مؤسساتية أو ديمقراطية داخل المغرب. لذلك لا أحد يستطيع عقابها على قرارات تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، فعندما قامت شركة رونو مثلا بتسريح جزء من عمالها أثناء جائحة كوفيد- 19، لم تتدخل أي مؤسسة لمساءلتها عن ذلك القرار.
هناك أيضا قرارات يكون لها وقع ضخم على الحياة اليومية للناس، ولكن لا صلاحية فيها لدى الحكومة، وهي السياسة النقدية. فرفع معدل الفائدة أو خفضه الذي يؤثر على الاقتراض الاستهلاكي وعلى الأسعار وقيمة العملة، كلها قرارات لا يتخذها البرلمان ولا الحكومة، بل بنك المغرب/ البنك المركزي.
مدير البنك المركزي ليس منتخَبا بل معيَّنا من طرف الملك. وللبنك استقلالية مالية وإدارية، أي مستقل عن أي رقابة، حكومية كانت أو برلمانية، وذلك بمبرر “حماية أفضل ضد أي تدخل غير مشروع أو أي حالة تضارب للمصالح في عملية صنع القرار”، كما ورد على موقع بنك المغرب.
من أجل سياسة اقتصادية في صالح الناس لا الشركات
رسخت العقيدة النيوليبرالية فكرة أن الحكومة عندما تتدخَّل في الاقتصاد إنما تشوِّه السوق ولا تتركها تعمل عملها التلقائي، وتمنع بذلك النمو والتنمية. وطيل العقود الثلاثة الماضية شهدنا مفارقة أن الحكومات في البلدان المتقدمة إنما فرضت النيوليبرالية على بلدان الجنوب العالمي، لتحرير اقتصاداتها وفتح أسواقها بما يخدم مصالح الشركات المتعددة الجنسيات، بينما تتدخل الدولة في بلدان الشمال بنشاط لدعم شركاتها وحماية أسواقها من منافسة اقتصادات بلدان الجنوب العالمي.
وفي بلدان الجنوب العالمي بدورها تتدخل الحكومات لصالح الرأسماليين المحليين لضمان حصة لهم في السوق المحلية والتفاوض على حصص في الأسواق الخارجية. لكن كلا الحكومات، في دول الشمال العالمي أو دول الجنوب العالمي، إنما تُسخِّر السياسة لخدمة الاقتصاد، لكنه اقتصاد يستفيد من الرأسماليون وخدامهم السياسيون.
لذلك وجب فتح نقاش من أجل إعادة الاعتبار للسياسة، سياسة تقرر اقتصادا يخدم مصالح الناس وليس مصالح الشركات والرأسماليين. يُحسَب لحراك جيل- زد بالمغرب أنه فتح نقاشا عموميا على منصة ديسكورد، يجري نشره على قناة يوتيب. وكان النقاش الأخير مع نجيب أقصبي مفيدا، وسيكون أفيد توسيع النقاش ليشمل ليس فقط خبراء الاقتصاد والصحفيين، ولكن أيضا المتضررين من السياسات الاقتصادية، مثل عاملات سيكوم- سيكومك وتنسيقية فيكيك…. إلخ.
فالاقتصاد والسياسة ليسا فقط شغل الخبراء والحكومات، بل هما المتحكم اليومي في حياة الناس اليومية، لذلك يجب أن يُسهم شباب جيل- زد في جعلهما شغل الناس اليومي، لكي تنقلب الآية ويتحكم الناس، عبر القرار الديمقراطين، في الاقتصاد والسياسة.
بقلم: علي أموزاي
================
إحالات
[1]- نعوم تشومسكي (1997)،”ضبط الرعاع”، حوارات أجراها معه ديفيد بارساميان، ترجمة هيثم علي حجازي، دار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، الطبعة العربية الأولى، صفحة 168. [2]- نفسه، ص 168- 169. [3]- جويس أبلبي (26-01-2017)، “الرأسمالية، ثورة لا تهدأ”، ترجمة رحاب صلاح الدين، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ص.217